
في العرف الديمقراطي الاصيل للدول الديمقراطية أن الرؤساء وحكموماتهم, الذين يصلون الى السلطة بإختيار حر من شعوبهم لهم يصبحون خاضعين –طول الوقت- لرقابة الشعب وممثليه في البرلمان.
وينتج عن ذلك أن إهتمام هؤلاء الذين يأتون الى السلطة عبر الإنتخابات الحرة ينصب لا حقا حول ارضاء ناخبيهم بكل السبل الممكنة. ومن ثمة فإن الرئيس "المنتخب" في هذه الحالة يجد نفسه مرغما على تجنب كل ما من شأنه أن يجلب له نقمة شعبه (ناخبيه) خوفا منه وطمعا. فهو مثلا يخاف من سلطة الشعب وممثليه في محاسبته إذا أساء التصرف من جهة. ومن جانب آخر هو يطمع فيما سيجنيه إذا قام بما عليه من خدمة شعبه على الوجه المطلوب. كأن يكافئه ناخبوه بإعادة إنتخابهم له من جديدة. فضلا عن ما سيسجل له في صفحات التاريخ من إنجازات قام بها خلال فترة حكمه اولايته في السلطة.
وعلى خلاف ذلك فإن الحاكم أو الزعيم الذي يأتي الى السلطة من دون أن يكون الشعب هو صاحب الفضل في وصوله اليها. –كما يحدث في الانظمه الديكتاتورية- فإن الرئيس أو الزعيم في هذه الحالة لن يجد في نفسه تلك الرغبة ولا الحاجة لارضاء المواطن (الناخب) الذي هو أصلا لم ياتي به الى الحكم. وبالاحرى أن يكون الشعب قادرا على محاسبته أو اقالته من منصبه حال خيانته او تفريطه في مصالح شعبه.
فيما سينصرف اهتمام هذا الصنف الاخير من الرأساء أو الحكام الى خدمة مصالح هؤلاء الذين هم السبب الحقيقي وراء تبوؤهم للمنصب. مثل المؤسسة العسكرية مثلا ان كان قد وصل عبر الانقلاب أو اللوبيات ومراكز الضغط ايضا ان كانت هي من مكنته أو ذللت له الطريق للوصول الى السلطة.
وعبر التاريخ توجد أمثلة حية كثيرة قديما وحديثا, حول تصرفات الحاكم الذي تم إختياره من شعبه وكيف يعامله باحترام. و ضبطه لتصرفاته وتكييفها وفق التفويض الذي منحه له الشعب بادارة الدولة عبر انتخاب ديمقراطي. وبالطبع فإن تفويضه ذلك ليس شيكا على بياض يسلم للرئيس المنتخب. بل هو محدد بضوابط كثيرة تجله يخضع دوما لرقابة الشعب سواءا عبر ممثليه في البرلمان, أو عن طريق الصحافة والقضاء و المجتمع المدني.
بالاضافة الى الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.
فالرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي اذا, يظل مكبلا بمجوعه لا متناهية من "العوائق والعراقيل" الرقابية التى تحاسبه على كل خطوة يخطوها بميزان المصالح العامه. بحيث أن أي تصرف "غير محسوب" يصدر منه قد يأدي به ليس الى العزل وفقد منصبه وحسب, بل الى المحاكمة والسجن كذلك.
وأجد هنا مثالا معبرا عن تلك الصورة حتي تتضح لنا اكثر. وهو قصة أنور السادات و"بيغن" لدلالتها على ذلك.
يورد "مناحين بيغن" رئيس الوزراء الاسرائيلي في مذكراته عن بعض ما كان يحدث داخل أروقة مفاوضات إتفاقيات كامب ديفيد الشهيرة. حيث يسرد بيغن -فيما يشبه "الطرفة" (رغم مرارتها). أنه والسادات عندما كانو اثناء المفاوضات, فان امريكا كانت تقدم لهم عرض معين لنقاشه وسماع رايهم فيه ثم موافقتهم عليه. يقول فإن السادات كان رده بالموافقة على المقترح الامريكي شبه جاهز, ودون نقاش كبير منه للعرض. بينما كان على بيغن أن يأخذ طائرته ويعود الى اسرائيل ليناقش المقترح مع الحكومه والكنيست الإسرائليين. ثم يحمل الرد بعد ذلك الى كامب ديفيد ليسلمه للامريكيين بالموافقة أو الرفض بحسب مالتفقت عليه الحكومه و الكنيست الاسرائيلي.
وليس خافيا أن الفرق بين الرجلين أن أحدهما وهو بيغن ياخذ في حساباته ان وراؤه رقيب سيحاسبه إذا أخطأ أو تجاوز وهو شعبه وممثليه. بينما لم يكن صاحبنا (السادات) مجبرا على ذلك لأن سلطته "المطلقة" لم يستمدها من الشعب، إذ ان الشعب المصري ليس هو صاحب الفضل في وصول السادات الى السلطة.
لذلك فهو ليس مدين له بشيء. ويرى أنه في حل من استشارته والرجوع اليه حتى ولو تعلق الامر بقضاياه المصيرية.
فالرئيس السادات تصرف في كامب ديفيد وفق مزاجه وأهوائه, لعلمه بأنه لا معقب لحكمه ولا رقيب يمكن أن يحاسبه على أفعاله وذلك برغم خطورة الموقف وجسامة الخطب.
ومن هنا وعلى قاعدة أن الشيء بالشيء يذكر. وفي اطار الجدل الدائر في الساحة الوطنية حول ضعف النسبة الموريتانية من عائدات حقل الغاز المشترك مع الجارة السينغال. 7% الى 18% فإن بعضامنا ربما يظلم الجنرال -الرئيس- عزيزعندما يطلب منه ان لا يفرط أو يتنازل عن بعض ما "نراه" نحن ملكا للشعب. بينما قد يراه الرئيس أو يعتقد أنه حقه الذي إكتسبه بقانون القوة.
ذلك أن الرئيس أحد تلاميذة مدرسة السادات- انفة الذكر- التى أرست دعائم حكم الفرد في العصر الحديث في بلداننا. ولا تزال الاوطان مع الاسف رهينة لتلك المدرسة وتلامذتها في أنظمة الحكم وحتي اشعار جديد. او يغار حاكمنا المستبد من احترام السفاح "بيغن" لبني جلدته فيحترمنا هو ..!!
الكاتب الحسين ولد النقرة
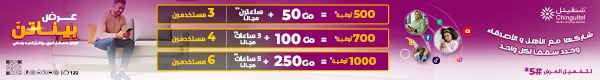

















.jpg)








